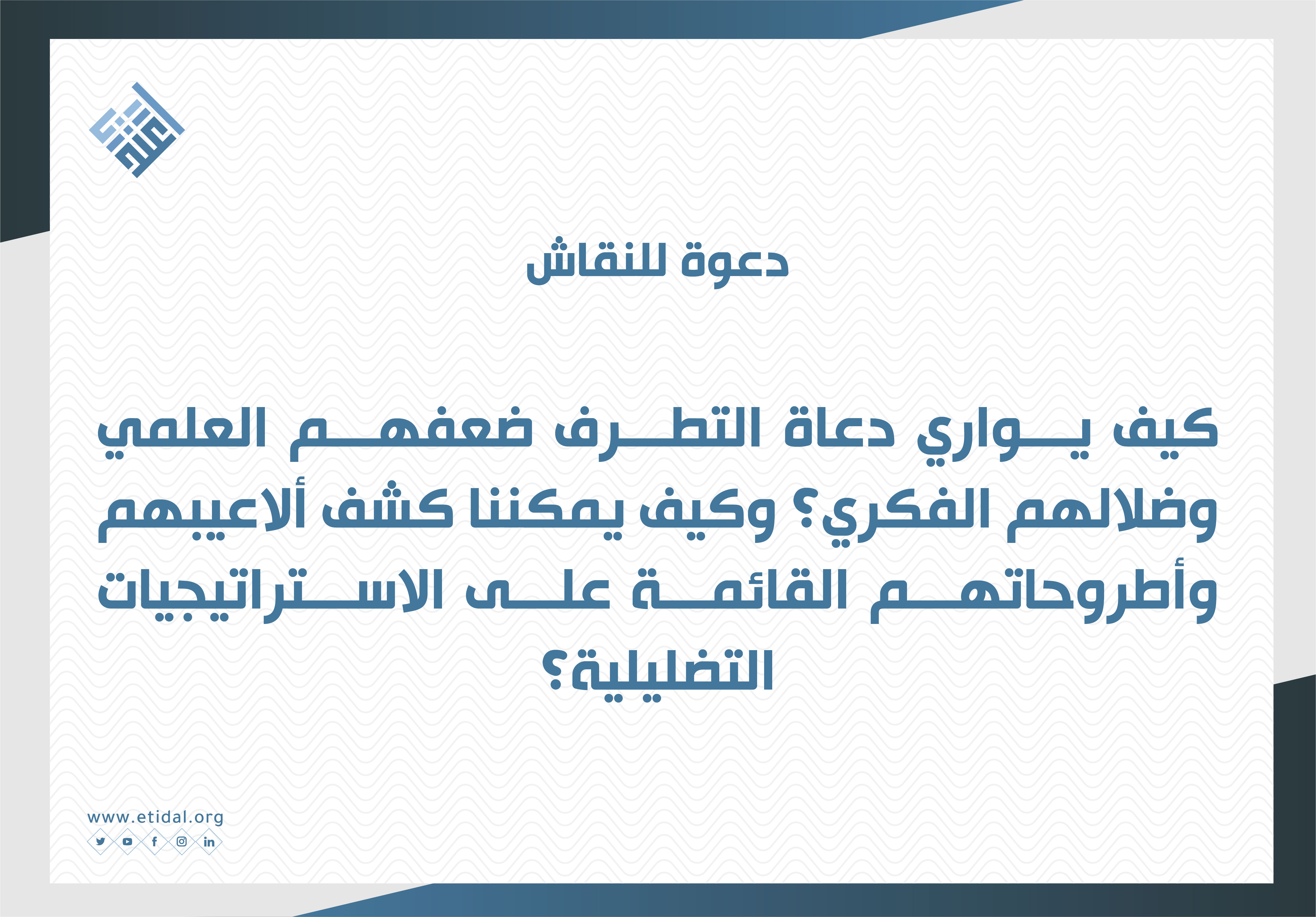الخمول الفكري، والميل إلى الاستسهال، والإحجام عن بذل جهد النظر والتفكير وإعادة التفكير، هي حزمة من العوامل المترتبة عن غياب التفكير الناقد التي تخلق بيئة خصبة لتنامي التطرف، وخصوصًا أن التطرف كظاهرة فكرية لديه قدرة هائلة على استغلال الكسل الفكري، لتمرير مقولاته المخادعة وأفكاره الضالة حول مختلف القضايا التي تواجهنا حيال الحاضر والماضي والمستقبل، بل يمكن القول أن استراتيجية الاستقطاب لدى الجماعات المتطرفة تراهن على بث عناصر الخمول في أذهان الناس، وجرهم إلى أطر معرفية محدودة وضيقة، يعتاد التابع أن يدور في حدودها، ولذلك من يخالف هذه الأطر أو يتجاوزها، يصاب برهاب الاغتراب، فيزداد تشنجًا وتشبثًا بما أطره ورسَّخه دعاة التطرف في رأسه من أفكار، تمثل له الأمان والنجاة والخلاص، ولهذا فهو يقابل كل محاولة لإخراجه من هذا الاستلاب والارتهان الفكري بالكثير من العدائية، التي في الواقع ماهي إلا التجلي الواضح لميكانيزم المقاومة النفسية، مما يساعده للإفلات من مواجهة تناقضاته، وهزالة القواعد الفكرية لمقولاته المتطرفة.
وهكذا يمكن القول أن محاربة الكسل في طرق التفكير والمقاربة والتحليل، بتمكين العقل الناقد هي أحد أهم المداخل لإضعاف التطرف وتأثيراته، ومنع التنظيمات المتطرفة من استغلال شبكات التواصل الاجتماعي في تمرير أفكارها المدمرة وسردياتها الكاذبة المزيفة، التي تعمل على نشرها عبر المجالات الرقمية، مستغلة طبيعتها الغوغائية التي تحاول استغلال المشاعر وإثارتها عبر استراتيجيات مختلفة من التأثير التي لا تكلف أتباعها أي جهد للفهم والتحليل، وذلك باستغلال البعد العاطفي من خلال انتهاز حماساتهم وانفعالاتهم ومخاوفهم، فتصوغها على شكل حكايات بطولية تداعب من خلالها خيال المتلقي، مما يوقعه في نوع من الخَدَرِ الفكري، الذي ينتهي في آخر المطاف إلى تشكيل تلك القناعات الغريبة التي تجعل المتطرف يعتقد أنه يفهم كل شيء، ولديه الحلول لأي عارض في الحياة البشرية، رغم أن محك الواقع دائما يُكذب مثل هذه الادعاءات الكاذبة والمغلوطة، التي تستغل الميولات النرجسية لدى من له استعداد لذلك، فتضخم تمثلاته حول نفسه، وتجعله يعتقد دونما بذل أي جهد يذكر، أنه الأكثر علمًا والأقوى إيمانًا والأطهر سريرةً، بينما كل من يخالفه الرأي يُوصم في منطقه المريض، بأسوأ النعوت وأشنعها، وعلى رأسها الجهل وعدم المعرفة، والافتقاد إلى المعلومة، وعدم التفطن للمؤامرة التي تفسر بالنسبة للمتطرفين كل شيء، وإن كانت هي نفسها غير قابلة للتفسير، ومن الأساليب التي يرسخ من خلالها التطرف هذا الكسل الفكري مايلي:
- أولًا: الاعتماد على القراءات السطحية المجتزأة؛ فالثقافة الفكرية للتطرف مبنية على المرويات المزيفة والقصص الخيالية، أما مقولاتها الشرعية حينما تُعرض على أهل الاختصاص تتحول في إطارها إلى كلام مرسل لا دليل عليه؛ بل إلى حالة من استغلال النص الشرعي والعبث به لتحقيق أهداف دنيئة، تؤكد بشاعة التطرف وجرأته على المعتقدات نفسها؛ وحينما يؤصل أهل الاختصاص اجتهاداتهم حسب ضوابط صارمة، ترى دعاة التطرف في الشبكات الاجتماعية يكيفون الأحكام دونما اكتراث للتفاصيل والسياقات والخصوصيات، وهذا ما يدفعهم لمُوَارَاة ضعفهم العلمي خلف هالة من البطولة الوهمية، وعوض أن يتبينوا الحق قبل أن يصدعوا به مثلما يدعون، تراهم يفاخرون برعونتهم وجرأتهم على النصوص وأهل الاختصاص والمؤسسات المعنية، ويختلقون ملاحم زائفة، كان الزمن دائمًا كفيلًا بكشف كوارثها المدمرة في الكثير من الحالات، بل وفي حالات أخرى اعتذر بعضهم بعد مراجعات قاسية، على ما قارفه في حق النصوص الدينية، من تصرفات محرجة للمعتقدات نفسها، أما مقولاتهم المتعلقة بالأنساق المعرفية الكبرى، فأحاديثهم لا تتجاوز أضغاث من الملخصات التي لا علاقة لها بحقيقة هذه الأنساق، التي تحتاج إلى جهد كبير لمتابعة تفاصيلها، وفهم أطروحاتها القائمة على استدلالات معقدة وملتوية، ولهذا فإن ملخصاتهم في هذا المجال، هي مجرد احتيال استهلاكي يستغل الميل إلى التبسيطية، الذي ينتهي بمعارف هشة متهافتة، لا تقدم نقدًا ولا نقضًا ولا اعتراضًا، القائمة على الاستدلال الزائف وعلى الجدل غير العلمي المعتمد على المراوغة والتزوير.
- ثانيًا: ثقافة الشعارات هي ما يمثل الاستراتيجية الثانية، وهي نتيجة للسبب السابق ذكره، لأن الذي لا يملك زمام أمره الفكري، ولا يستطيع أن يتابع تفاصيل ما يدرسه ويفكر فيه، لن يكون قادرًا إلا على الترويج للشعارات الغوغائية، المليئة بالتهديد والكراهية والعنصرية، فالشعار هو وسيلة خطيرة في استراتيجية البروباغندا المتطرفة، لأنه يُعلم أتباعه الاستغناء عن التفكير والبحث من الأساس، والاكتفاء بجاذبية الشعارات التي تتحول إلى بديل رديء للمعرفة، وتلك الجمل والعبارات الرنانة التي يحاول المتطرفون أن يبثوها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لا تعدو أن تكون جملًا إنشائية لا يمكن التحقق منها على مستوى الاختبار المنطقي والموضوعي، لأنها تعبر عن انفعالات ورغبات وليس عن أطروحات مؤسسة معرفيًا واستدلاليًا، لذلك إن تسفيه الشعارات الرنانة، ووضعها في حجمها الحقيقي، قد يزعج بعض الكسالى الخاملين، لكنه يوقظ همم الراغبين في المعرفة، ويساعدهم في مغالبة إغراء الخمول المعرفي، وفي البحث عن يقظةٍ حقيقية لا يمكنها أن تتحقق إلا بالكثير من الجهد والتركيز.
- ثالثًا: الاستعاضة عن المفاهيم والأفكار بالسرديات الحكائية، وهذه من أدعى الاستراتيجيات لثقافة الكسل والخمول الفكري، فحينما نعتقد أن خلف كل ظاهرة حكاية غامضة، وأن تفسيرها لا يحتاج غير تتبع حبكة الحكايات التي لا يعرفها غير المتطرفين، يشِق حينئذ على العقل بذل الجهد لتفسير وفهم الظواهر المختلفة من خلال منهج علمي صارم، بل قد يصل الأمر إلى فقدان الحاجة إلى الدليل، ويصبح التصديق والثقة بديلًا عن التحليل وبناء الأدلة وترتيبها، وإذا ما حدث ذلك فإن التطرف بحكاياته التي لا تنتهي لا يتطلب من الأتباع أن يستوعبوا التفاصيل الفكرية، بل يحولهم إلى حالة من الجمود والسذاجة الفكرية فيتابعون حكاياته بالكثير من الشغف والحماس، في افتقاد كامل للحس التحليلي والنقدي.
- ختامًا: لا بد إذن من محاربة الكسل الثقافي والمعرفي والفكري، لأن التطرف يستغل ذلك الخمول ويَتَعَيَّشُ به، ويجب ألا نُضيع على أنفسنا فرص بناء مناعة فكرية قائمة على جهد البحث والتمحيص والتكوين الذاتي المستمر، لنعمل على منع التطرف من بث سمومه وأفكاره وثقافته الغوغائية، ونحمي عقولنا من مخاطره من خلال المزيد من الجهد والتفكير، ومن الأهمية أيضًا خلق مناخ تعليمي وتربوي وإعلامي يشجع على بذل الجهد لاستيعاب المقاربات الفكرية، التي تخلق لدى الفرد المناعة ضد التطرف.