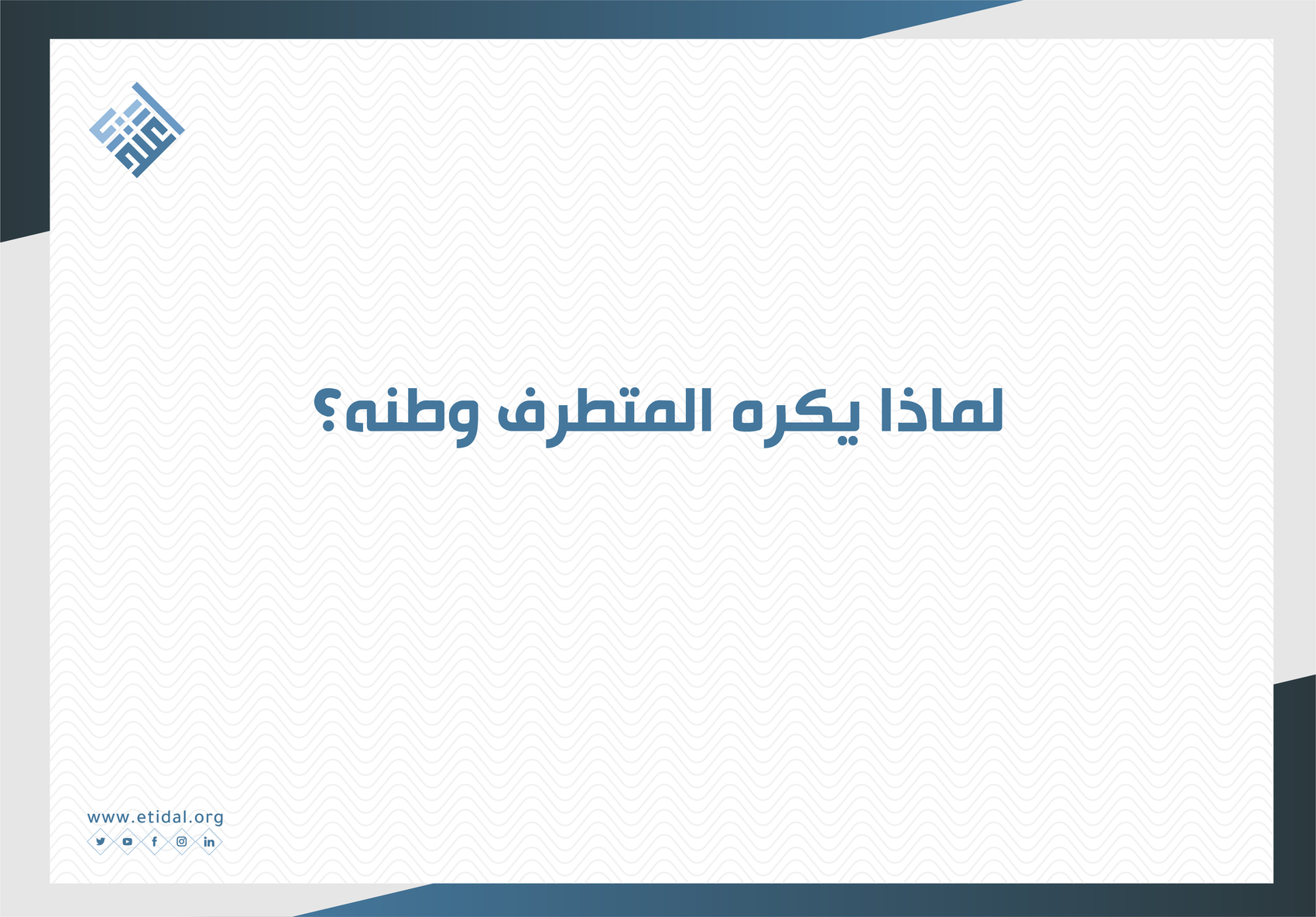التطرف الفكري يُفقد الإنسان كل معنى للاتزان وفهم الآخر على النحو الصحيح، ويربك معاييره الأخلاقية والمعرفية فيتحوّل إلى كائن بغيض؛ وهو يعادي المخالفين ويدعو بالويل على كل من لا ينتمي إلى تنظيمه، فكأن التطرف هو قبل كل شيء إعاقة في قدرة الفرد على التواصل مع الحياة، لأن كل الرذائل التي تترتب عن تبنيه لأفكار ومواقف متطرفة، هي نتيجة لتلك العُزلة التي يَغرق فيها من لا يرى في الناس إلا أعداءً ينبغي محاربتهم، أو ضُلَّالًا يَلزم نهيهم والتشديد عليهم في القول والفعل، حتى يعودوا عن غيهم، ويتبنوا نفس المواقف التي يراها المتطرف عينَ الحقِ وجوهر الفضيلة.
المتطرف هنا هو كائن وحيد رغم انشغاله الكبير بالناس وحشر أنفه في تفاصيل حياتهم، وذلك لأن التضخم المرضي الذي يعتري كل من يرفض التواصل والحوار البناء مع الآخر، على أساس اعتقادٍ راسخ بأنه يملك مفاتيح الحقيقة وحده، كل ذلك يحرمه من القدرة على سماع صوت الناس، فلا يتردّد داخل رأسه سوى ما رسمه له عرَّابُوه باعتباره صوت الحق الأوحد الذي ينبغي أن يُتبع، كما يمنع عنه ذلك القدرة على رؤية الناس كما هم في بساطتهم وعفويتهم، لأنه يُسقط عليهم ما يدور في فكره من ضغائن وأحقاد إيديولوجية، فلا يرى بسبب ذلك إلا الأشياء المقيتة التي يتخيلها في المجتمع، وهي في الواقع من أفكاره المريضة، فلا يتعب من القذف في الأعراض، واتهام ذممهم كلما صادف لديهم احتفاءً بالحياة، وانتشاءً بسعادتهم الشخصية.
وعدم قدرة المتطرف على مشاركة الناس أفراحهم، هو أيضًا باب من أبواب الغربة التي يعيشها بفعل ما رسخ في ذهنه وقلبه من أفكار لا تتسع لسعادة الناس، ولا ترضى أن ترى في كل مكان سوى بؤس الرذيلة، وظلمات الضلال، ونذائر الكوارث. إن الغطرسة الإيديولوجية التي يحاول أن يواريها المتطرف خلف أقنعة الشجاعة الزائفة، والمبادئ المزعومة، هو ما يجعل المتطرفين غير قادرين على الاندماج في مدن الناس، ولا الانخراط في مساراتهم التنموية، لأن أمرًا كهذا يقتضي أن يكون لدينا شعور بالثقة في الآخر وبالحاجة إليه، وبالاعتراف بأن أي شخص يشاركنا الفضاء العام، يمكنه أن يساهم في نجاح حياتنا، إذا ما انخرطنا معًا في مشاريع حضارية عامة، تتظافر فيها الجهود، وتتشابك الكفاءات مهما كانت مختلفة، لكي تشكل قوة الجماعة في صورتها التعاونية الراقية مما ينعكس على الوطن بالرُقي والتطور، أما فالحال هنا فإن المتطرف فقد هذه الثقة بشكل مرضي، ولهذا كلما ازداد درجة في مراتب التطرف، إلا وابتعد عن الحضارة، لينتهي به الحال شريدًا في كهوف الإرهاب، وفي أحراش المعسكرات الإجرامية، وهو بهذا يفقد الأمن والأمان فتراه يشعر بأنه طريد الجميع، وتزداد غرابته إلى أن تصل حد التوحش بفعل فقدان الثقة، وفي ذلك نقاط عدة نطرحها هنا، ومن بينها:
- أولًا، المتطرف لا يثق في أسرته، التي يتنكر لها ويراها بؤرة فاسدة، عليه أن يهرب منها وينفصل عنها، لأن هذه الأسرة هي التي ربته على تلك القيم التي تدعو لاحترام الناس والتكافل معهم، وقبول تباين الطبائع والاختيارات، وهي التي علمته احترام الجار مهما كانت مواقفه، والتهيب من حرمات الوطن، والدفاع عنه، إلا أن مكارم الأخلاق والمبادئ العظيمة هذه تتحول تحت تأثير أدبيات المتطرفين المثخنة بخطابات الإدانة والتجريم والقذف في الأعراض إلى قيمٍ ضالةٍ ينبغي محاربتها باسم مُثُلٍ أخلاقية زائفة، لا توجد إلا في الأذهان المريضة لمنظري التطرف، وهكذا يفقد المتطرف وشائج قرابته، ويتنكر لمن سهر على تربيته، ولمن شاركه الطعام والمنام والمسكن، فتجده ينظر إليهم كأعداء لا عهد لهم معه ولا أمان، بل قد يصل التطرف ببعضهم، إلى درجة من التحول العجيب، الذي ينتهي بهم إلى تغيير أسمائهم بأسماء وكُنى تنظيمية، ليتنكر هنا لاسمٍ اختارته له عائلته احتفاءً بانتمائه لها في صغره بعد طول تربيةٍ ودعمٍ ورعاية، وما يكاد يشتد ساعده بفضل جهود عائلته، حتى ينقلب عليها في خبث وجحود.
- ثانيًا، المتطرف أيضًا لا يثق في وطنه وفي مؤسساته، رغم أنه تعلم في مدارس هذا البلد، ونال الرعاية الطبية في مستشفياتها، واستفاد من هويتها للتنقل بين البلدان وهو يحمل جواز سفرها، ويحظى بحماية وضمان مؤسساتها الأمنية، ومع ذلك وفي أقرب فرصة لا يجد أي حرج في مناصبة بلده العداء، بل والسعي إلى دعم من يتآمر على وطنه، مباركًا ومشجعًا ومشاركًا، وهو إذ يفعل ذلك يزداد غرقًا في بحار العُزلة التي ألقى بنفسه نحوها، لأنه يتحوّل مع مرور الوقت إلى أداة يُستعمل من طرف الآخرين كوسيلة ترتهن قيمتها بمدى الحاجة إليها، وتُرمى كشيء تافه حينما تُستنفذُ قيمتها الاستعمالية، على عكس قيمته وهو مواطن في بلده، حيث يحظى برعاية مؤسسات بلده مهما كان شأنه وقيمته. إن هذه الحالة من الضياع التي يعيشها المتطرفون وهم يتنقلون من مهرب إلى مهرب، وهم يمارسون خطابتهم البغيضة من بوق إلى بوق، ومن ركنٍ إلى آخر، تجعلهم يعيشون قلقًا دائمًا من لحظة انتهاء صلاحيتهم، فتراهم يبالغون في شحن خطابهم بمفردات النكاية والتشفي والحقد، لكي يثبتوا لتنظيماتهم أنهم منخرطون في استماتة ضد أوطانهم، لكن لأن خيانة الأوطان سُبةٌ ومَعرةٌ تضفي على الإنسان صورة مثيرةً للاشمئزاز والازدراء، فإنهم مهما يحاولون إقناع الآخرين بوفائهم الإيديولوجي، فإن قيمتهم تنهار بسرعة، لأن من يخون وطنه لا يمكن أن تستأمنه أوطان غيره، وهذا ما يجعل مآل المتطرف ينتهي إلى العيش متخفيًا وهاربًا وخائفًا.
- ثالثًا، المتطرف يعادي البشرية جمعاء، فيمنعه ذلك من الانخراط مع الناس، أو من السعي للمساهمة في دعم المجتمع، وعوضًا عن ذلك يركّز على أي مثلب يصادفه، فيحاول تضخيمه وترويع الناس به، ودفعهم إلى الكفر بالقيم الحضارية، ومشاركته إياه واجب كراهيتها ومعاداتها، وهذا ما يوقعه بشكل تلقائي في التوحش والدموية والتخلّف. إن المتطرف يعيش وحيدًا في هذا العالم لأنه يرى في نفسه الكائن الوحيد الذي يحق له الوجود والسيادة، وبالتالي فهو لا يقبل التعايش التطوّر الحضاري، مما يجعله يبذل قصارى جهده في إحداث أضرار توقف عجلة التقدم والتنمية، وهذا ما نشهده من هجوم المتطرفين على مشاريع وطنية أو عالمية عبر شبكات التواصل أو التخطيط لعمليات إرهابية، لأن حدوث التطور هو شهادة بنجاح الحضارة المعاصرة في تحسين حياة الناس، حيث ساد التعليم، وأصبحت الخدمات الصحية للجميع بفضل الابتكارات العلمية، كما أن التكنولوجيا التي أصبحت في متناول الجميع، ففتحت أبوابًا كثيرة من الاتصال الحضاري، وكل هذه المؤشرات الإيجابية للحضارة المعاصرة تستفز المتطرفين، ولهذا يطالعوننا بعدائهم غير المبرر للأنظمة التعليمية المعاصرة، ويشيطنون التكنولوجيا رغم أنهم مهووسين بتملكها واستعمالها، بكل بساطة لأن التعليم والصحة والتقدم العلمي يجعل الناس يشعرون أنهم يعيشون في إطار حضارة كونية مشتركة، والحال أن المتطرف بتوحشه النفسي يخشى مثل هذه المشاعر التي تشجع الانفتاح والتواصل الإنساني العام، فهو يحب أن يعيش في جُحْرِه الإيديولوجي يعادي العالم.
- ختامًا، المتطرفون بحكم تضخم ذاتيتهم المرضية فيصلون لعزلة اجتماعية وانغلاقٍ حضاريٍ، وهذا يجعل المتطرف سجين نفسه، حتى دون أن يقترب منه أحد، فهو يعاني لوحده من غربة تشكّلت أول الأمر في صورة أفكار مسمومة في ذهنه، لتتحول بالتدريج نحو التجسد في صورة شخصية تعاني من إعاقة حضارية واجتماعية أحدثها المتطرف بشكل طوعي في نفسه.