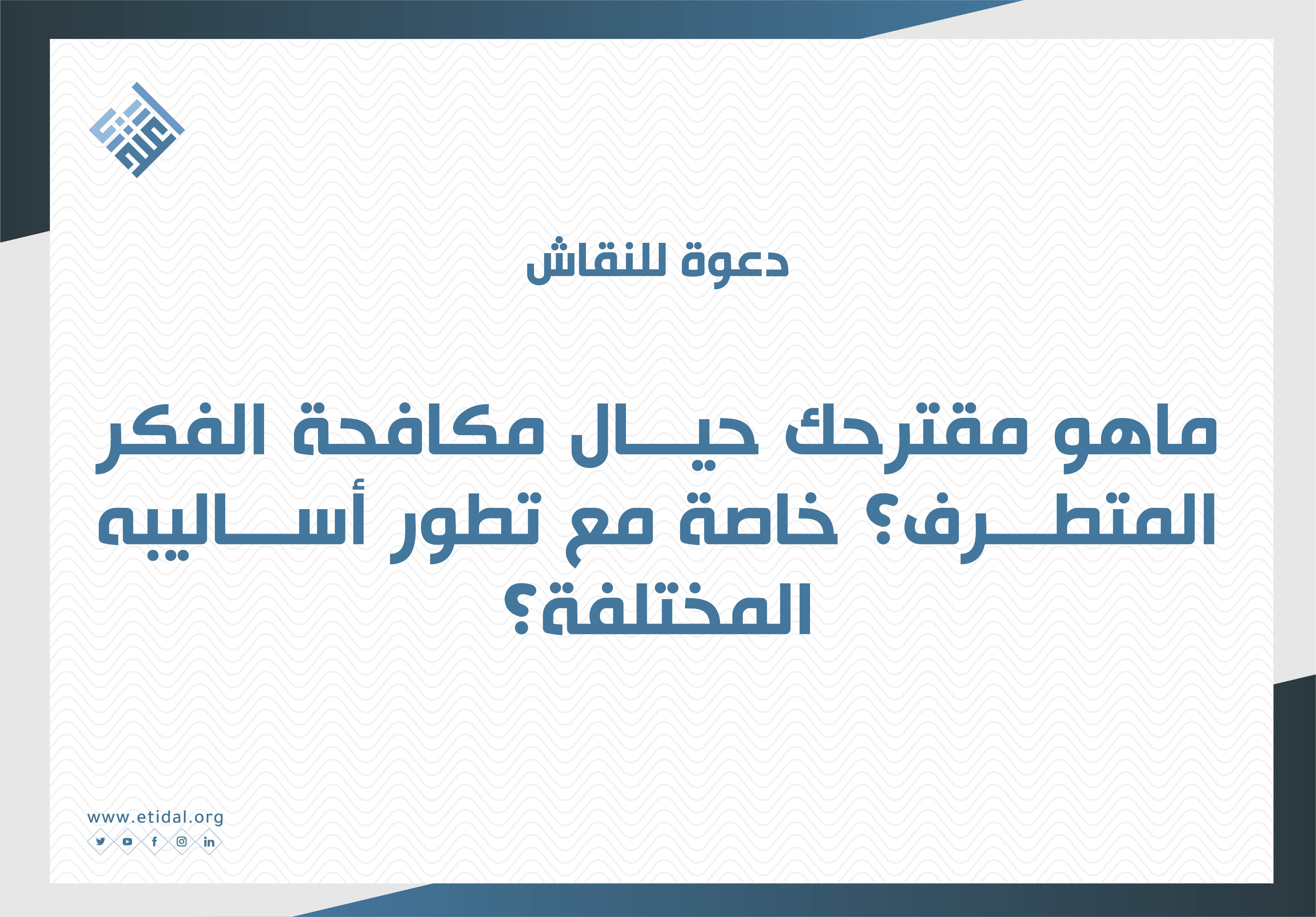رغم ما يبدو من ولع المتطرفين بالحديث عن جماعاتهم، والوفاء الأعمى لكل ما تُقرره لهم من اختيارات ومواقف، فإن السمة الغالبة على المتطرف في مختلف مسارات انزلاقه نحو حواضن التطرف والإرهاب هي على وجه التحديد الشعور بالعزلة، التي يقع في قبضتها بفعل استسلامه للخطاب الاستقطابي للجماعات التي لا تتوانى عن شيطنة المجتمع، وتبخيس قيمة الأسرة، والدعوة للخروج عن الثوابت الأصلية للمجتمعات، وذلك لأجل تبرير الأجندة الإرهابية التي تقوم من حيث المبدأ على معاداة شاملة لكل طرف لا يتبنى إيديولوجيتها.
لهذا يُمكن القول إن الطريق إلى الجماعات المتطرفة هو قبل كل شيء فقدان للوشائج الرابطة ما بين الفرد ومجتمعه، وبالتالي إن العزلة هي حقيقة التطرف، وإعادة الإدماج هي السبيل الوحيد التي يُمكن أن تخرج المتطرفين من الحلقة المغلقة للتطرف التي بقدر ما ينتمي إليها شخص ما، إلا ويبتعد أكثر فأكثر عن هويته الأصلية، مما يفقده اتزانه في نهاية المطاف، بحيث يُصبح ينظر إلى العالم أكمل بأنه لا يضم إلا أعداء يستحقون كل أشكال العداء مهما بلغت درجات دمويتها وعنفها، دون أن يميز في ذلك بين قريب أو بعيد، أو بين طفل أو عجوز، بل إن عزلته هذه قد تصل به إلى القدرة على تبرير سفك دماء الأم التي حضنته والأب الذي رعاه، وذلك في وضع يصل إلى أعلى درجات التوحش والغرابة، ويمكن إرجاع عزلة التطرف إلى ثلاثة هي التالي:
- أولًا: المعزل الفكري ويتشكل من ذلك السياج الإيديولوجي الذي يحيط المتطرف به نفسه، بحيث يقتصر في تغذية وعيه فقط على ما يُقدم له من طرف الجماعة التي ينتمي إليها، والتي كما هو معلوم تضع له منهاجًا يتدرج به نحو العقيدة الإرهابية بشكل تكويني، إذ يُختطف المنتمي إلى الجماعات المتطرفة في الغالب من حضن مجتمعه، حينما تنجح الجماعة في ترسيخ استخفافه وتسفيهه لما تقدمه له البرامج التربوية الرسمية من مناهج، وهو إذ يفقد ثقته في المدرسة كمصدر للمعرفة، يصبح صيدًا سهلًا للجماعات، التي تقنعه بأن المعرفة الحقة هي ما يكتبه ويُقدره منظروها الذين يقدَّمُون له باعتبارهم كائنات استثنائية، وهنا تبدأ عملية الغسل العميق للأدمغة الذي ينتهي بخلق تلك الكائنات المفتقدة لكل حس نقدي، والتي تكرر في حماقة ما تلقن بشكل آلي، دون أن تمنح لنفسها حق المراجعة أو النقد أو التبيُّن، وحينما يشرع الفرد في التفكير على نحو صادم بالنسبة للمجتمع، تتحول علاقته معه إلى صراع مستمر، مما يؤدي إلى إقصائه من طرف معارفه حينما ييأسون من إمكانية تعديل طرائق فهمه للأشياء، فيدخل في تلك العزلة الفكرية التي يحاول التحايل عليها من خلال النظر إلى نفسه على أساس بطولي وهمي، بحيث يقنعه المكلفون باستقطابه، بأن الغربة هي مصير الصادقين، فيزيده ذلك تمسكًا بالوهم والجهل، معتقدًا أنه يملك من المعرفة ما لا يتيسر لغيره.
- ثانيًا: المعزل السلوكي وهو في الواقع نتيجة للمعزل الأول، إذ تحرص الجماعات على جعل أتباعها يحملون علامات تمييزية، تسجل ابتعادهم عن الناس، ولهذا تتدخل في أسلوب لباس أتباعها، وكذلك في طريقة تعبدهم الطقوسية، التي يحاولون دائما أن يظهروا أنفسهم من خلالها أنهم الأحرص على الوفاء للأصل، بينما كل من سواهم يمارسون سلوكًا مرفوضًا، بل إنهم يجعلون مثل هذه التفاصيل الصغيرة تأخذ حيزًا كبيرًا في سجالهم مع المجتمع، وينطلقون منها كي يؤسسوا إدانتهم الأكثر جذرية له، حيث نجد أن تهمة التخوين تغلب على أدبياتهم فيما يتعلق بسلوكيات المجتمع، التي كلما جدَّ عليها شيء إلا واعتبروه خيانة للأصل، ودليلًا على ضعف الإيمان والانتماء، فيبالغون في تسجيل اختلافهم ورفض الاندماج والقبول بسُنَّة الحياة القائمة على قانون التطور، من خلال طريقة اللباس والعيش والحديث التي يغلب عليها التصنع والغرابة، إلى درجة أن أغلب المتطرفين حينما يصلون إلى شوط بعيد في مجال غسل الأدمغة يبدون كما لو أنهم يؤدون دورًا مسرحيًا، بحيث لا يسلكون ولا يتحدثون إلا بقدر ما يُلقنون قبلًا من طرف زعمائهم في التطرف والإرهاب، وهذا ما يجعل المتطرف رغم ما يظهر عليه من تحدٍ لمجتمعه ومؤسساته، مجرد شخص محجور عليه من طرف غيره، فقد حريته واستقلاليته بشكل طوعي، فتحول إلى شخصية مستلبة تمامًا لا تملك من أمرها شيئا.
- ثالثًا: المعزل الحضاري والقيمي، ويتشكل من تضافر المعزلين السابقين اللذان يؤديان به إلى تبني منظومة قيم خارج التاريخ، تنطلق من قطيعة مع كل القيم الكونية التي تؤمن بها الإنسانية في الوقت الراهن؛ وإن الرفض الحضاري الجذري الذي ينطلق منه المتطرفون وهم يرفعون شعاراتهم الإرهابية التي تتوعد العالم بحرب كونية لا تُبقِ ولا تذر يجعلهم يفقدون تمامًا كفاءتهم الحضارية فيسقطون في التوحش القيمي، حتى وإن حاولوا موراته خلف بلاغتهم المزيفة التي لا يملون من تكرارها، لأن ثمن دعوتهم لإصلاح العالم هو تدميره من الأساس، وبالتالي فإن الخيال المريض للمتطرف غارق في هلوسات دموية بشعة، فهو لا يتخيل نفسه إلا وهو يحز الرؤوس وينشر الرعب، وهذا ما ترسخه قنواته الإعلامية التي لا تتورع عن نشر الصور المرعبة لأشكال القتل والتدمير مصحوبة بعبارات الفرح والسعادة والامتنان، فالإنسان المعاصر في تصور المتطرفين مهدور الدم من حيث المبدأ، وما يحول دون قتله ليس شيء آخر غير عدم القدرة، التي تأتي نتيجة لصلابة الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب؛ لأنه لو ترك كي يُنزِّل تصوره للإصلاح، فإنه سيصل إلى نوع من الردة الحضارية التي تتجلى في تلك المشاهد الدموية الاستعبادية التي قدمتها الجماعات المتطرفة أمام العالم حينما تمكنت من تدبير بعض المناطق الجغرافية بفعل ظروف سياقية خاصة، والمتطرف بهذا المعنى هو عدو للحضارة، يداعبه دائما حلم تدمير المؤسسات الدولية، والآثار التاريخية، وكل تجليات الحضارة الإنسانية، نظرًا لكون عقيدته الإرهابية تجعله ينظر إلى نفسه ككائن لا علاقة له بأي من التفاعلات الإنسانية الكونية، وهذا ما يجعله يعيش في غربة حضارية تُحكم السياج حوله بحيث يفقد كل مرتكزاته الإنسانية، بعد أن فقد مرتكزاته الاجتماعية والفكرية.
- ختامًا: ليس من اليسير إخراج المتطرف من العزلة هذه إذا ما أنهى دورة السقوط في مهالكها البعيدة، لأنه مع مرور الوقت يتحول إلى كائن موصد تمامًا أمام كل محاولات التواصل والحوار، لكن بإمكاننا العمل سويًا لأجل منع وقوعه في هذه العزلة من الأساس، وذلك أولًا بتوفير تعليم منفتح يشجع على التفكير والنقد والإبداع، وثانيًا الإنتباه للجانح في بداياته وتفعيل دور حواضنه الاجتماعية لحمايته من مخاطر التطرف وخصوصًا في ظل تطور أساليبه المختلفة في عمليات الاستقطاب، وثالثًا منح الشباب فرصًا دائمة للتفاعل الحضاري الإيجابي، لكي يشعروا بأنهم جزء مهم من الحضارة الكونية دون أي إحساس بالدونية، ولا أيضًا شعورٍ بالتفوق الحضاري، وهذا ما يتحقق بزرع قيم التسامح والتعاون فيهم منذ نعومة أظافرهم.