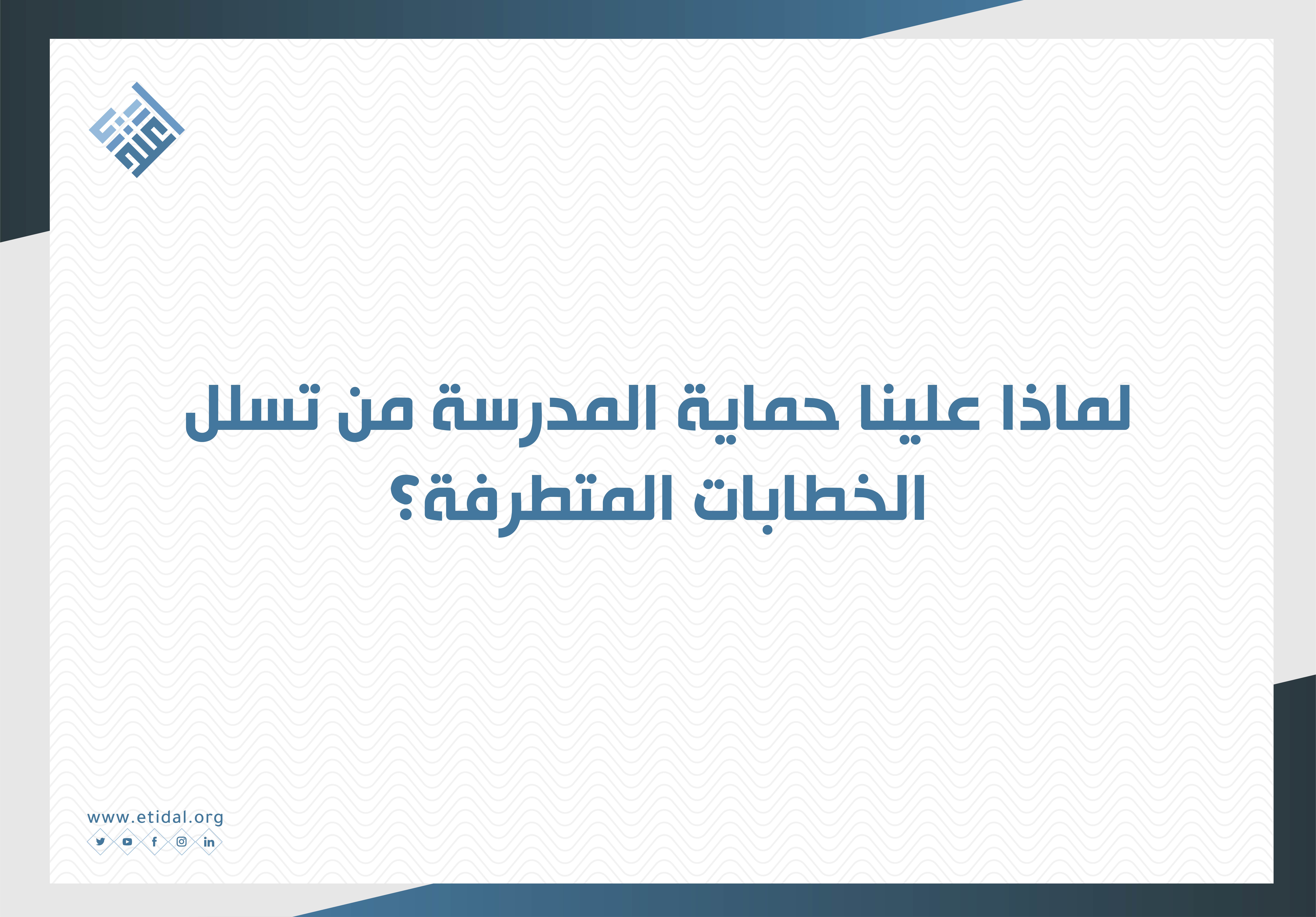يحتاج الطفل إلى وقت كي يتشكل وَعيَه البسيط بذاته، قبل أن تضطلع الأسرة والمدرسة عمومًا بعد ذلك بمسؤولية إدماجه الثقافي من خلال ما يدعوه علماء الاجتماع بالتنشئة الاجتماعية، التي تتضمن إكساب هذا الطفل اللغة الأم وعبرها منظومة القيم التي تجعله مع مرور الوقت ثريًا بمقومات هوية مجتمعه العامة، وبالتالي يصبح فاعلًا حقيقيًا داخل هذا المجتمع، حيث يحقق من خلال سلوكه التلقائي دونما أي توجيه أو إكراه خارجي ملامح المجتمع وسماته، ومن ثمة يضمن بقاء هذا المجتمع واستمراره، وهنا تبرز قيمة المدرسة في تعزيز هذه الهوية من خلال عدة نقاط من بينها:
أولًا: إن المدرسة هي في المقام الأول مكان لإعادة إنتاج الأسس الصلبة للهوية الوطنية للمجتمع، ثم هي بالإضافة إلى ذلك المؤسسة التي تمنح الأجيال الناشئة الأدواتَ المعرفية والتقنية التي تسمح لهم بتحمل تحديات مجتمعاتهم حينما تناط بهم المسؤوليات العامة، في مستقبل يتحدد في الغالب بعد عقدين من جلوس الطفل لأول مرة على طاولة الدراسة، لهذا يمكن القول إن المدرسة تنجح في بناء المواطن الصالح، حينما تكون قادرة على أن تجعله متصالحًا مع ذاته ومع مجتمعه، واعيًا للماضي التاريخي لبلده، وتؤهله لكي يندمج بسلاسة في راهنه الحاضر، وتسلحه بما يتناسب مع مستجدات مستقبله، فهذا التكوين الثلاثي الأبعاد يقتضي أن نعطي للمتعلمين فرصة كي يفهموا عمق مجتمعهم الحضاري، ويتبينوا مدى تلاقحه وتفاعله الإيجابي مع باقي الحضارات الأخرى، دونما تفخيم مبالغ يؤدي إلى نوع من العصبية والإحساس بالنرجسية، أو تبخيس يرسّخ في الطلاب النقص في ذواتهم تجاه الآخر الذي يقارنون أنفسهم به، خصوصًا وأن انفتاح المتعلم على الماضي ينبغي أن يزاوج بين الأبعاد المحلية والعالمية من غير أن يُغلّب أحدهما على الآخر؛ ومن المهم أيضًا أن ينتهي التكوين في هذا المجال إلى إكساب الأجيال المقبلة حسًا تاريخيًا يتصف بالواقعية، ويشجّع القبول بفكرة اقتسام العالم على أساس التعاون والتكامل، وليس الصدام والكراهية.
ثانيًا: من المهم أيضًا أن يكون لدى الطلاب حس بالمسؤولية حيال مجتمعاتهم، فالطالب لما يبني مشاريعه التعليمية على أساس رغبة قوية في الانخراط داخل خطط بلاده التنموية، فهو ينظر إلى المدرسة وإلى التعليم عمومًا كبوابة للنضج الفعلي، وكطريق لأن يتحوّل إلى عنصر قوة في حاضر بلده، وهذا الإحساس هو ما يميز المدرسة الفاعلة عن المدرسة الصورية، ففي الأولى يتلقى الطالب ما ينفعه في حاضره، وما يجعله مؤثرًا بشكل إيجابي، بينما في الثانية يُستغرق هذا الطالب في الأبعاد الروتينية للتحصيل المدرسي، ولهذا فهو يقضي جل وقته في تكرار ما يُلقن به، دون أن ينشغل بتحويل ذلك إلى مهارة عملية يمكنها أن تحقق مساهمة في حل مشاكل واقعه، وفي إبداع اقتراحات تتجاوز ما تلقاه من مدرسته، وهكذا تبني السياسة التعليمية المتنورة مقومات المواطن المبدع، أو تكون في المقابل مجرد عمل صوري نتاجها عقول هشّة.
ثالثًا: إن الإيمان القوي بالمعرفة، والحماسة العامة في تلقيها، واكتشاف تطبيقاتها المبهرة، وفعاليتها في الانتصار على ما يصادف واقعنا من تحديات، يعطي للطلاب شغفًا بالعلم، وامتنانًا للعلماء، وما علينا إلا ان نستحضر البشرية وهي تنتظر نتائج مشاريع المختبرات البحثية كلما صادفنا كوارث وبائية أو طبيعية تهدد الحياة، لكي نكتشف قيمة العلم وأهمية اكتساب أدواته، لكن ذلك لا ينبغي أن يتحوّل إلى مجرد انبهار استعمالي سلبي بالتقنية، بل من المفترض أن يستوعب الطالب روح الحضارة الحديثة التي تكمن في الرهان على قيم العقل والتعاون والعمل، وهذا الوعي هو ما يربط الحماسة للعلم، بالرهان على بناء مشاريع كبرى تمتد من الحاضر نحو المستقبل، وهكذا دواليك، فهذه الأحاسيس الإيجابية نحو المستقبل ينبغي تشجيعها من قِبل المؤسسات التعليمية، ورفد الطلاب في المدارس بما يجعلهم متحمسون كي ينخرطوا في منظومة المجتمع المحيط بهم، دون التفات إلى خطابات متطرفة تحاول استقطابهم وتجنيدهم لتدمير ذواتهم ومجتمعهم.
رابعًا: إن المتطرف عدو للمستقبل، حيث يراه دائمًا على شاكلة سوداوية كئيبة، لهذا فأفكاره وأجنداته دائمًا ما تدفع نحو الهدم وليس البناء، نحو الفناء وليس الإعمار والتنمية، لذا فمنع المتطرف من مصادرة حق الطلاب من خلال المؤسسات التعليمية في أن يحلموا بغدٍ مشرق يسكن مستقبلهم وينتج عن جهدهم في التحصيل والإبداع، ينبغي أن يؤخذ بالجدية اللازمة، خصوصًا وأن كل خطاباته كارثية تدفع نحو الإحباط واغتيال كل طموح، وهذا ما يمكن للمدرسة أن تحققه من خلال الإعلاء من قيمة التقدم وقيمة المساهمين في تحقيقه، والقيم الإنسانية كافة التي تساعد على ذلك، والعمل بكل قوة على استدامة التوعية وتطوير أدواتها وأساليبها.
ختامًا: من المهم الانخراط الجماعي في حماية المدرسة من كل العوامل السلبية، فداخل تلك البنايات يتشكّل المستقبل، وإذا ما سمحنا للإيديولوجيات المتطرفة بأن تتسرب نحو هذا النشء الفتي الذي علينا مسؤولية حمايته وهو في هذا العمر الصغير، فإننا سنعرض بذلك ماضينا للتشويه، وحاضرنا للفشل، ومستقبلنا للانهيار، فالمدرسة هي قلب المجتمع وقد ظلم نفسه من أهمل قلبه.
أولًا: إن المدرسة هي في المقام الأول مكان لإعادة إنتاج الأسس الصلبة للهوية الوطنية للمجتمع، ثم هي بالإضافة إلى ذلك المؤسسة التي تمنح الأجيال الناشئة الأدواتَ المعرفية والتقنية التي تسمح لهم بتحمل تحديات مجتمعاتهم حينما تناط بهم المسؤوليات العامة، في مستقبل يتحدد في الغالب بعد عقدين من جلوس الطفل لأول مرة على طاولة الدراسة، لهذا يمكن القول إن المدرسة تنجح في بناء المواطن الصالح، حينما تكون قادرة على أن تجعله متصالحًا مع ذاته ومع مجتمعه، واعيًا للماضي التاريخي لبلده، وتؤهله لكي يندمج بسلاسة في راهنه الحاضر، وتسلحه بما يتناسب مع مستجدات مستقبله، فهذا التكوين الثلاثي الأبعاد يقتضي أن نعطي للمتعلمين فرصة كي يفهموا عمق مجتمعهم الحضاري، ويتبينوا مدى تلاقحه وتفاعله الإيجابي مع باقي الحضارات الأخرى، دونما تفخيم مبالغ يؤدي إلى نوع من العصبية والإحساس بالنرجسية، أو تبخيس يرسّخ في الطلاب النقص في ذواتهم تجاه الآخر الذي يقارنون أنفسهم به، خصوصًا وأن انفتاح المتعلم على الماضي ينبغي أن يزاوج بين الأبعاد المحلية والعالمية من غير أن يُغلّب أحدهما على الآخر؛ ومن المهم أيضًا أن ينتهي التكوين في هذا المجال إلى إكساب الأجيال المقبلة حسًا تاريخيًا يتصف بالواقعية، ويشجّع القبول بفكرة اقتسام العالم على أساس التعاون والتكامل، وليس الصدام والكراهية.
ثانيًا: من المهم أيضًا أن يكون لدى الطلاب حس بالمسؤولية حيال مجتمعاتهم، فالطالب لما يبني مشاريعه التعليمية على أساس رغبة قوية في الانخراط داخل خطط بلاده التنموية، فهو ينظر إلى المدرسة وإلى التعليم عمومًا كبوابة للنضج الفعلي، وكطريق لأن يتحوّل إلى عنصر قوة في حاضر بلده، وهذا الإحساس هو ما يميز المدرسة الفاعلة عن المدرسة الصورية، ففي الأولى يتلقى الطالب ما ينفعه في حاضره، وما يجعله مؤثرًا بشكل إيجابي، بينما في الثانية يُستغرق هذا الطالب في الأبعاد الروتينية للتحصيل المدرسي، ولهذا فهو يقضي جل وقته في تكرار ما يُلقن به، دون أن ينشغل بتحويل ذلك إلى مهارة عملية يمكنها أن تحقق مساهمة في حل مشاكل واقعه، وفي إبداع اقتراحات تتجاوز ما تلقاه من مدرسته، وهكذا تبني السياسة التعليمية المتنورة مقومات المواطن المبدع، أو تكون في المقابل مجرد عمل صوري نتاجها عقول هشّة.
ثالثًا: إن الإيمان القوي بالمعرفة، والحماسة العامة في تلقيها، واكتشاف تطبيقاتها المبهرة، وفعاليتها في الانتصار على ما يصادف واقعنا من تحديات، يعطي للطلاب شغفًا بالعلم، وامتنانًا للعلماء، وما علينا إلا ان نستحضر البشرية وهي تنتظر نتائج مشاريع المختبرات البحثية كلما صادفنا كوارث وبائية أو طبيعية تهدد الحياة، لكي نكتشف قيمة العلم وأهمية اكتساب أدواته، لكن ذلك لا ينبغي أن يتحوّل إلى مجرد انبهار استعمالي سلبي بالتقنية، بل من المفترض أن يستوعب الطالب روح الحضارة الحديثة التي تكمن في الرهان على قيم العقل والتعاون والعمل، وهذا الوعي هو ما يربط الحماسة للعلم، بالرهان على بناء مشاريع كبرى تمتد من الحاضر نحو المستقبل، وهكذا دواليك، فهذه الأحاسيس الإيجابية نحو المستقبل ينبغي تشجيعها من قِبل المؤسسات التعليمية، ورفد الطلاب في المدارس بما يجعلهم متحمسون كي ينخرطوا في منظومة المجتمع المحيط بهم، دون التفات إلى خطابات متطرفة تحاول استقطابهم وتجنيدهم لتدمير ذواتهم ومجتمعهم.
رابعًا: إن المتطرف عدو للمستقبل، حيث يراه دائمًا على شاكلة سوداوية كئيبة، لهذا فأفكاره وأجنداته دائمًا ما تدفع نحو الهدم وليس البناء، نحو الفناء وليس الإعمار والتنمية، لذا فمنع المتطرف من مصادرة حق الطلاب من خلال المؤسسات التعليمية في أن يحلموا بغدٍ مشرق يسكن مستقبلهم وينتج عن جهدهم في التحصيل والإبداع، ينبغي أن يؤخذ بالجدية اللازمة، خصوصًا وأن كل خطاباته كارثية تدفع نحو الإحباط واغتيال كل طموح، وهذا ما يمكن للمدرسة أن تحققه من خلال الإعلاء من قيمة التقدم وقيمة المساهمين في تحقيقه، والقيم الإنسانية كافة التي تساعد على ذلك، والعمل بكل قوة على استدامة التوعية وتطوير أدواتها وأساليبها.
ختامًا: من المهم الانخراط الجماعي في حماية المدرسة من كل العوامل السلبية، فداخل تلك البنايات يتشكّل المستقبل، وإذا ما سمحنا للإيديولوجيات المتطرفة بأن تتسرب نحو هذا النشء الفتي الذي علينا مسؤولية حمايته وهو في هذا العمر الصغير، فإننا سنعرض بذلك ماضينا للتشويه، وحاضرنا للفشل، ومستقبلنا للانهيار، فالمدرسة هي قلب المجتمع وقد ظلم نفسه من أهمل قلبه.