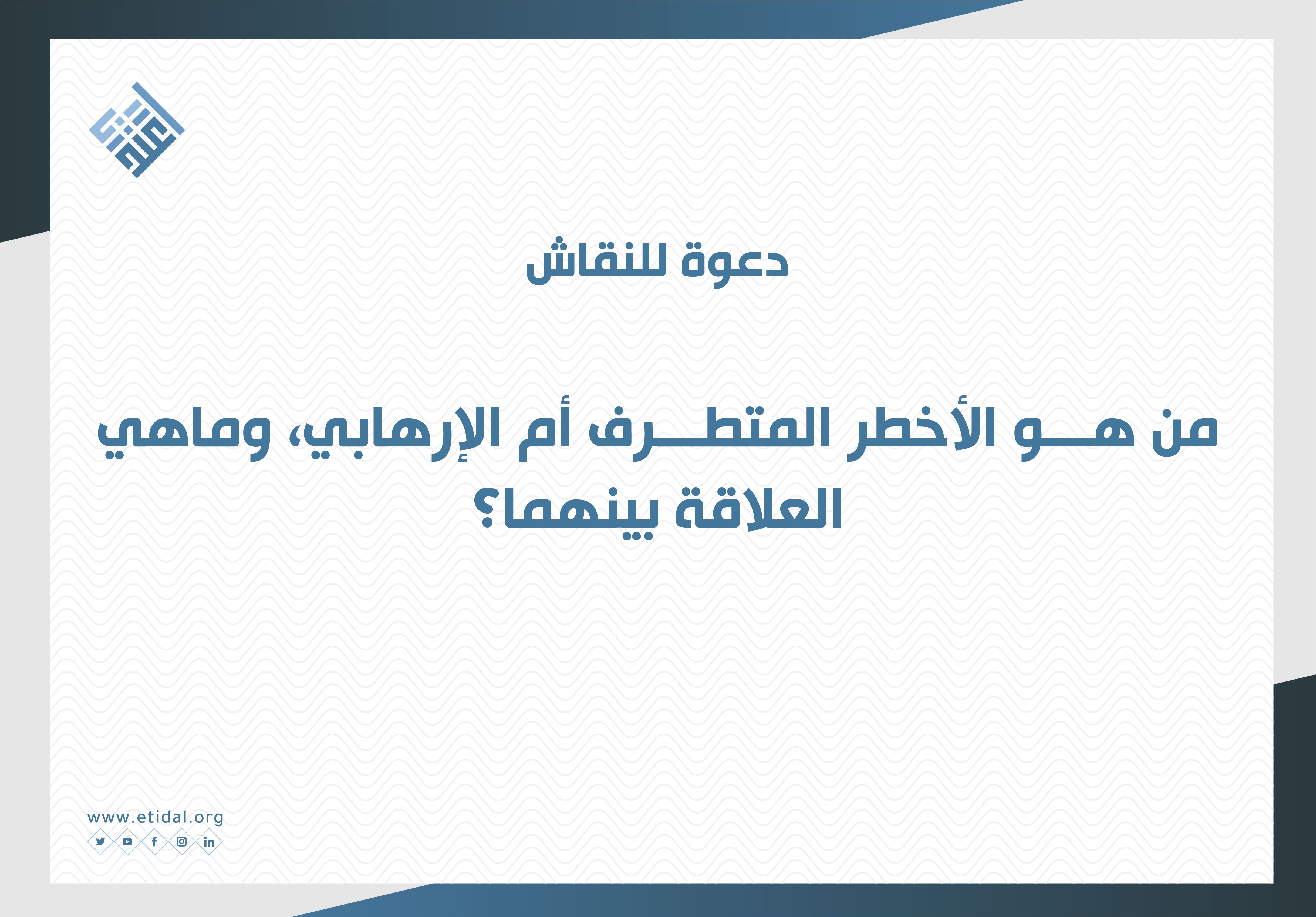لا يبدو وجه الشر دائما واضح المعالم، حاسمًا في تمايزه عن غيره من الوجوه بحيث يسهل التعرف عليه من أول نظرة، بل هو في الغالب يسعى إلى اعتماد منطق الخلط والاشتباه والتواري والمخاتلة والمراوغة، ولهذا علينا أن لا ننتظر من الشر أن يعلن عن حقيقته بشكل صريح، فلا بد من إعمال أدوات التحليل والتمحيص لبلوغ تمييزه وكشفه وفضحه، وهذا التحدي هو ما ينبغي استحضاره ونحن نحلل ظاهرة الإرهاب والتطرف.
فإذا كانت الأولى جريمة دموية بشعة؛ مكتملة الأركان واضحة المعالم، فإن ظاهرة التطرف تطرح صعوبات أكبر أمام ميزان النظر والتحليل، لأن التطرف لا يصل في كل الأحوال إلى درجة الممارسة المكشوفة، بل هو في الغالب يمضي مراحل طويلة من الكُمُون الصامت، والتفاعل المبهم للانفعالات القاتلة البئيسة، قبل أن يَنْبَجِسَ على حين غِرة في صورة صادمة للنزوعات الإرهابية، ومن المهم محاولة التمييز الدقيق بين صورة الإرهابي المكشوفة وبين أوجه المتطرف المتداخلة والضبابية، لأن كل إرهابي هو متطرف باليقين، لكن ليس كل متطرف بالضرورة قد وصل إلى درك الإرهاب، حتى وإن كان يحمل قابلية هذا التحول باستمرار، ويمكن تحديد بعض ملامح هذا التداخل المعقد بين الإرهابي والمتطرف فيما يلي:
- أولًا: إن الإرهابي هو نتاج التطور المرضي والإجرامي الأخطر لحالات التطرف، إذ لا يكتفي المتطرف في هذه الحالة بحمل قناعات متشددة، وعداءات عميقة للمجتمعات والدول، بل ينتقل إلى المرحلة الجنائية الصريحة، عبر العمليات الإرهابية التي يكون الغرض منها إشاعة الخوف وعدم الاستقرار، ومحاولة خلق حالة التشكيك لدى المجتمعات وتهديد أمنها وسلامها، وهنالك علاقة ارتباطية بين الهشاشة الأمنية وبين تنامي الظاهرة الإرهابية، فبقدر ما يكون الوضع الأمني مستحكمًا في قوة ومتانة عبر مؤسساته المختلفة، بقدر ما تكون فرص العمليات الإرهابية ضئيلة، فلا تتعدى مستوى التحضير والتخطيط العملياتي الذي ينكشف سريعًا، لكن ما يكاد هذا الوضع يُصاب بالتراخي والهشاشة، وفقدان اليقظة المطلوبة، حتى تنتقل الظاهرة من مستوى التخفي والتخطيط والأزمة العابرة، إلى صورة البِنية المزمنة، وهذا ما يُمثل كارثة عظمى لا تعرف وقعها ولا توحشها إلا المجتمعات التي فقدت مناعتها أمام هذا الوباء المخيف، الذي يضع الدول في درجة التدمير الذاتي، ويقوض الروابط الدستورية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية، فيجعلها مجالًا سائبًا تُمزقه التنظيمات المتطرفة في مشهد افتراسي مخيف، وكلما انتقل الإرهاب من مستوى الأزمة إلى مستوى البِنْيَةِ، يُصبح حالة صريحة لا يحتاج المرء إلى كثير من الجهد كي يميزها عن باقي الحالات الإجرامية الأخرى، حتى وإن اختلطت بها ونسَّقت وتعاونت معها، لأن ما يُميز الإرهاب الذي رُصدت له قوانين خاصة في الأنظمة الجنائية عن باقي أشكال الجريمة المنظمة، هوعدميته الوظيفية، حيث أنه على خلاف الجريمة التقليدية لا يتطلع فقط إلى تحقيق مكاسب مباشرة، بل يُراهن على تدمير المجتمعات والدول، لأسباب إيديولوجية تبرر له أقصى درجات العداء، وهذا في الواقع ما يجعل الإرهاب درجة عُليا من الجريمة المنظمة، وهو ما خلق الحاجة إلى قوانين خاصة بالإرهاب.
- ثانيًا: إذا انتقلنا إلى مستوى التطرف، فعلينا أولًا أن نرسم تلك الحدود المتداخلة بين التطرف كقناعات فاسدة، وبين كونه مساهمة مباشرة في التخطيط والتسويغ الصريح والمُعلن للإرهاب، ففي هذه الحالة يكون التطرف نفسه جزءًا من الظاهرة الإرهابية، ويُصبح لديه تبعات جنائية، وذلك أمر واضح على المستوى القانوني الذي يُعاقب على فعل الجريمة والمشاركة فيها؛ فإضفاء الشرعية على ثقافة التدمير والخروج عن القانون والتحلل من التزامات المواطنة والانتماء إلى التنظيمات السرية الإرهابية، هو فعل قصدي يُشكل خطرًا أعمق من العمليات الإرهابية نفسها، لأنه إذا كانت الأخيرة لا تعدو وضع الحادث الطارئ المحدود على مستوى الزمان والمكان، فإن الآلية التبريرية للإرهاب تُحول هذه العملية إلى مبدأ شرعي، ومن هنا تضمن استمرارها وانتقالها إلى جهات أخرى، لذلك يُمكن القول أن الإرهاب الفكري هو أساس الإرهاب العملياتي ومرتكزه وغطاءه الإيديولوجي، ومفتاح تحوله من جريمة جنائية إلى جريمة إرهابية، أما الجانب الآخر لدرجات التطرف فيتمثل في الفيروسات الفكرية التي تُضعف مناعة الإنسان الأخلاقية والاجتماعية، وتخلق لديه حالة التشنج العدائي تجاه كل من يخالفه، وهو ما يجعله يخطو نحو التشوهات الأخرى تباعًا؛ التي تبتدئ بالكراهية والعنصرية وعدم التسامح مع الآخر المختلف، إلى أن تصل إلى درجات عميقة في الدعوة إلى العنف وتمجيد التوحش باسم مُثُلٍ عُلْيا، وهو ما يؤكد أن وجه التطرف أكثر امتناعًا عن الانكشاف من الإرهاب، نظرًا لتداخل ملامحه وكثرتها، ويمكن القول أن كل ما يعطل قدرة العقل على الحوار والتواصل مع الآخر المُختلف، هو عرَض من أعراض التطرف؛ إذ ما تكاد تنتفي القابلية لتنويع زوايا النظر، وعدم القدرة على فهم ما لا يدخل في إطار القناعة الخاصة بالشخص، إلا ويتحول الفكر نحو الأُحادية، التي هي من أكثر صفات التطرف شيوعًا، فعقل المتطرف لا يسع إلا فكرًا واحدًا، ولهذا إن تكريس هذه الأحادية من خلال تعطيل شروط التواصل السليم والحوار البناء، يُمكن أن يعتبر المرحلة الأولى من الإصابة بحالة التطرف، وكذلك عدم التمييز بين الفكرة وبين الشخص، الذي يعتبر مدخلًا من مداخل التطرف الأساسية، ويتجلى هذا الخلط في الاعتقاد أن كل فكرة صادرة عن شخص مخالف، لا مجال للنقاش والحوار فيها، بل هي تهمة قائمة تقتضي كراهيته لأجلها، والطعن في ذمته وعقيدته، وتغذية مشاعر الكراهية حياله، ولهذا فإن الحوار حينما يتحول إلى محاكمة للآخرين، والتسرع في توزيع التهم والمثالب التي تحط من قيمة الأشخاص خارج ضوابط القانون، على أساس الميول الذوقية أو الفكرية، كل ذلك يعتبر تطرفًا يؤدي مباشرة إلى خطاب الكراهية والعنصرية وعدم التسامح.
- ختامًا: يُمكن القول أن كل إرهاب هو تطرف بالضرورة، وكل تطرف هو بشكل من الأشكال تدرج محتمل نحو مهالك الإرهاب، وإذا كان هذا الأخير واضح الملامح، وقابلًا للمقاربة الأمنية، فإن التطرف أكثر تعقيدًا، ويحتاج منا متابعة لتحولاته وموارباته وتوارياته، وإن الحذر واليقظة الفكرية وتشجيع ثقافة الحوار والتواصل السليم هي أحد الطرائق الأكثر فعالية في تحصين مجتمعاتنا وأنفسنا من ذلك الشر المخادع الذي يُقدم نفسه تحت هويات زائفة، ولا ينكشف من تلقاء نفسه، إلا بقدر ما نبذله من جهد كي نكتشفه في مخابئه، ونكشفه تحت ضوء التفكير والبحث والتحليل.