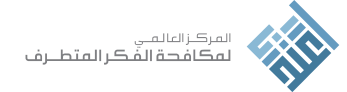د. منصور الشمري
الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف – «اعتدال»
إنّ التاريخ يشهد بأن منطقة الشرق الأوسط مثّلت الأرض التي انطلقت منها قيم روحية، والتي لا تزال إلى وقتنا الراهن تلعب دور المرجع الأخلاقي لجانب كبير من البشرية. ففي هذه المنطقة ظهرت الديانات التوحيدية الثلاث، وعبر هذه الأرض امتدت طرق التجارة العالمية، وكانت بمثابة شرايين حيوية سمحت للعالم بأن يتبادل أرقى ما تُنتج صناعاته من بضائع نادرة وفاخرة، وعبرها أُتيح للحضارات فرصة التلاقي والتلاقح الثقافي واللغوي والفكري، ولذلك فقد كان الشرق الأوسط موطناً لأكبر المدارس الفكرية، والحلقة الرابطة بين تراث الإنسانية، ويُعتبر ذاكرة العالم التي حفظت علومه من الزوال.
إلا أن منقلبات التدافع الكبير بين قوى العالم، والنقلة الحضارية الحاسمة منذ نهاية القرن التاسع عشر، قد غيّرت كل المعطيات ومنحت الأولوية لمنطق المصالح العملية، لا سيما الاقتصادية منها، وهنا انقلبت المعطيات الحضارية للعالم بأكمله، الذي تغيّرت ملامحه دونما حساب للخصوصيات الثقافية والأنثروبولوجية واللغوية للمجال الذي تقع فيه تدافعات الخطط الاستراتيجية للقوى الفاعلة.
ما الذي حدث بفعل ذلك؟ لقد تغيّر منطق العالم تماماً، وتبدّلت آلياته في التعاطي مع التحديات، بل ووقعت داخله قطيعة كبرى مع الخطاب الفروسي والروحاني لـ«العالم القديم»، مُفسحة المجال للغةٍ جديدة، أكثر تقنية وبرغماتية وفاعلية، وهذا ما أحدث صدمة قاسية لدى كل أولئك الذين لم يستطيعوا استيعاب هذه المتغيرات في الوقت المناسب.
ولقد استمرت آثار هذه الصدمة منذ ذلك الحين، فخلقت أحياناً مشاريع تنادي بالتخلّص والتحلّل الكامل من الهويات القديمة، كما تسبّبت في المقابل برفضٍ شديد لدى أطرافٍ أخرى، تدعو إلى مزيدٍ من الارتداد إلى ما قبل العالم الحديث، معتقدةً بأن عجلة التاريخ يمكنها أن تدور في الاتجاه المعاكس، وأن الواقع القائم قابلٌ للزوال، بمجرد أن تُطلق في وجهه شعاراتٌ حماسية تستعيد لغة عصر قد مضى وانقضى.
وفي الواقع، إن هذا التمزّق بين فكرة القطيعة مع الماضي، وبين الانغراس الكامل فيه والتماهي معه، هو ما جعل منطقة الشرق الأوسط تُعاني من أزمة مُزمنة، لم تتوقف منذ عشرينات القرن الماضي عن تدوير الصراعات نفسها تقريباً، ومن خلال ذات الذهنيات التي لم تقم ببذل الجهد الكافي لإعادة تحديث رؤاها، في عالم عَرف منذ ذلك الحين قطائع كثيرة، ومرّ من خلال عتبات فارقة.
ومع ذلك، ظل في المنطقة إصرار على التصلّب داخل الوضع نفسه، وهذا ما انتهى بالكثير إلى الوقوع في نوعٍ من هوس النزعة الصراعية المُستدامة، التي تصوّر العالم كأرض معركة مفتوحة، لا يمكن أن تَحسِم قضاياها إلا بالمزيد من العنف، ومن تغذية مشاعر الكراهية والتعبئة الاستعدائية. ولا ينبغي الاعتقاد بأنّ هذه الذهنية كانت حكراً على مجموعة دون أخرى، بل هي منطق عميق وكامن يتجلى عبر لغاتٍ عديدة، وعلى أساس خلفيات دينية مختلفة، ومن خلال تنظيمات وحركات بأسماء متباينة، ومع ذلك فالمنطق الصراعي، رغم الاختلاف، هو الذي يوجهها ويؤسسها بشكل دائم.
وهنا، بُرر هذا الصراع في لحظات معينة من تاريخ منطقة الشرق الأوسط بلغة مُسلحة، فروّجت لنفسها على أساس أنها طريق الخلاص، واعتبرت أن السير نحو المعركة الكبرى لا بد أن يمر من عنف داخلي، فأصبحت معسكرات التدريب للميليشيات هي الحاضنة التي يُعاد فيها تشكيل الآيديولوجيات المتشددة عبر أجيالٍ من الشباب.
ثم بعد ذلك؟ لقد أُعيد إنتاج الذهنية الصراعية نفسها على أساس آيديولوجي جديد، في إطار تركيبة مُختلطة، تولّد عنها خطاب هجين لا هو متصالح مع ثوابته الروحية، ولا هو على وعي كامل بتبعات خطابه. وهنا ابتدأت موجة جديدة من بروباغندا شاملة للصراع، عبر صياغة خطابٍ آيديولوجي يستخدم سياقات تاريخية ويسقطها على الواقع الراهن حتى يصل إلى جمهور أوسع، مستغلاً طبيعة الوجدان الشرق-أوسطي القائم على التماهي مع قيمه الروحية وماضيه.
إنّ هذا الخطاب مثّل حالة من الانتهازية الثقافية، ومن ثَم ضربة قاصمة للتوازن النفسي والفكري لأجيال كثيرة، لم تنتبه وهي مأخوذة ببلاغة الصراع المفتوح، ولقد فوّتت هذه الأجيال على نفسها فرصاً تاريخية كبرى للحاق بركب المنافسة الحديثة، التي لا تنتظر أحداً في مسار مراكمتها لأسباب القوة والتقدم والرفاهية.
وللأسف، إنّ هذه الذهنية الصراعية، التي ظلت عالقة في أسئلة الماضي، وفي ردود فعل لم يعد سياقها قائماً من الأساس، كانت في هذه المنطقة هي الأكثر رواجاً بين الناس، نظراً لكون هذا المشروع الصراعي استفاد كثيراً من وصول ورسوخ مقولاته لدى أجيالٍ كانت ضحية ترسانة قوية من آليات التضليل الخطابية، مما رفع من قابلياتها للاقتناع بأن الخروج من الأزمة لا يتحقق إلا بدفعها نحو أقصى مداها العنيف في إطار معركة شاملة ومفصلية، وهذا ما تم انتظاره وترقبه لعقود، وفي طور هذا الانتظار الطويل ضاعت الفرص تلو الأخرى لبناء الحياة الكريمة، وانفلتت بفعل التحشيد والتعبئة ماكينة العنف فنالت من دماء من آمنوا بها أكثر مما نالت من أعدائهم المفترضين، وهكذا عوضاً عن أن تتمرس هذه الأجيال على التفكير في الأزمة، دخلت فيما يمكن دعوته بحالة الأزمة المُزمنة، التي أفقدتها رشدها السياسي والاجتماعي والفكري.
وفي المقابل، سطعت ذهنية استباقية استثنائية، استوعبت قواعد المنافسة، وفهمت التحديات، وأدركت مكامن القوة، ومنزلقات الخطر والاشتباك، فأسست سياستها وفهمها على وعي كامل بالممكن وغير الممكن، وركّزت في اتزانٍ وحكمة على بناء أوطانها بما يقتضي الوقت من معايير الحياة، وما يتناسب مع الانتظارات المعقولة والعقلانية، بعيداً عن احتدام البلاغة والفروسية -هذا حتى وإن كان الشرق الأوسط تاريخياً هو رائد هذا الخطاب في عصور متناسبة مع لغة الخيل والسيف- ومع ذلك فهذه الذهنية التي يمكن أن ندعوها بالنزعة الإصلاحية، فهمت بنباهة أن المُعجم الحديث ما عاد هو نفسه الذي عُبّر به في القرن التاسع عشر وما قبله عن أسباب القوة، وطرق إدارة الأزمات والتحديات.
ورغم أن نجاح هذه الذهنية الإصلاحية لم يأخذ نفْس التفخيم الدعائي الذي استفادت منه الذهنية الصراعية، فإنها أثبتت بالشواهد، كفاءتها في خدمة الحياة، وفي تقديم الحلول الفعّالة والمعقولة للكثير من التحديات التي استمرت لعقودٍ في الشرق الأوسط. لكن رغم هذا التفوق يظل مزاج الذهنية الصراعية هو الأكثر انتشاراً؛ إما من خلال بروباغندا قصدية خدمةً لمصالح ضيقة، أو نتيجة لمؤثرات آيديولوجية تنشر وترسّخ الرؤى الصراعية، وهذا ما سيؤثر لا محالة على أجيالٍ جديدة، إذا لم نقم بالواجب حيالهم فسيتخلّفون هم أيضاً عن موعدهم مع التاريخ، وسيضيّعون الفرصة بالانخراط الإيجابي داخل العالم المعاصر بما يقتضي من أدوات وكفاءات واستعدادات، ومن هنا، فإن الشرق الأوسط يتطلّب رد الاعتبار بقوة إلى ذهنية الحكمة الإصلاحية، وما يرتبط بها من مبادئ وقواعد في تجاوز الأزمات نحو النجاحات.
نشر في صحيفة “الشرق الأوسط” السبت 26-7-2025